القضية الكردية حين تتقاطع الهوية بالقضية وتصبح الإدارة ممرًّا للسيادة أو للانفصال
القضية الكردية ليست مسألة هوية فقط، ولا مجرد ملف حقوق ثقافية،
بل هي اليوم – بعد الحرب والانقسام والتدخل الخارجي – ملف سيادي مركّب
يتقاطع فيه:
- التعدد القومي
- تجربة الحكم الذاتي
- الصراع الإقليمي (تركيا–إيران–أمريكا)
- هشاشة العقد الوطني السوري
لذلك، لا يُمكن أن تُعالَج هذه القضية بالاستيعاب القسري، ولا بالانفصال، ولا بالإقصاء،
بل فقط من خلال إعادة تعريف الدولة السورية بوصفها وطنًا متعدد المكوّنات، موحَّد السيادة، متكامل الإدارة.
من بين جميع المكوّنات السورية، لا تحمل أي فئة من التحديات والرهانات المركّبة مثلما تحمله القضية الكردية.
فهي ليست مجرد مظلومية قومية مؤجلة، ولا مجرد حراك محلي ذي طابع ثقافي، بل هي عقدةٌ وطنية–سيادية–إقليمية في آنٍ معًا، تتقاطع فيها:
- الهوية القومية،
- الحق الثقافي،
- إشكالية التمثيل،
- الطموح السياسي،
- البُعد الجغرافي–الإداري،
- التوظيف الدولي،
- هشاشة المركز الوطني نفسه.
لقد تحوّلت القضية الكردية في سوريا، بعد عقود من الإقصاء، إلى كيان سياسي–عسكري قائم بحكم الواقع، يستند إلى دعم خارجي مباشر، ويتبنّى أطروحات تتراوح بين الفيدرالية القومية والحكم الذاتي الكامل، ويُدير شبكة مؤسسات موازية تتفكك فيها الحدود بين المحلي والوطني، وبين الإداري والسيادي، وبين التمثيل الثقافي والسلطة الفعلية.
وهذه التحوّلات، وإن جاءت في سياق من الظلم التاريخي، ليست محصّنة أخلاقيًا من النقد، ولا يمكن احتواؤها بشعارات الوحدة أو التخويف من التقسيم، بل تحتاج إلى تفكيك عقلاني عميق، يُفرّق بين الحقوق والمخاطر، ويصوغ رؤية إدماجية لا إنكارية ولا انفصالية.
القضية الكردية ليست خطرًا… الخطر في إنكارها أو تركها تُدار من خارج الدولة
لسنوات طويلة، تعاملت الدولة السورية مع الأكراد باعتبارهم جماعة هامشية يجب تدجينها أو تفتيتها أو صهرها.
– تم نزع الجنسية عن مئات الآلاف منهم،
– وتم منع لغتهم وثقافتهم،
– وتُركوا خارج التمثيل السياسي،
– وتحوّل مجرد ذكر هويتهم إلى تهمة.
وبعد 2011، وبينما كان المركز السوري ينفجر ويتشظى،
ظهر الأكراد بوصفهم المكوّن الوحيد الذي استطاع إنتاج نموذج حكم مستقر نسبيًا، تمكّن من:
- فرض الأمن المحلي،
- إدارة الموارد،
- بناء تحالفات دولية (خاصة مع أمريكا)،
- وفرض لغة تفاوض على الجميع.
هذا لم يكن نتيجة مشروع انفصالي مباشر، بل نتيجة فراغ في السيادة أنتج طموحًا قابلًا للتوظيف.
الإشكالية ليست في الهوية الكردية… بل في غياب العقد الوطني
حين يشعر مكوّن قومي بأنه:
- غير مُمثَّل،
- غير معترف به،
- غير محمي،
- غير شريك في القرار،
فإنه سينتج – بحكم البديهة – شبكته الخاصة من الحماية والتمثيل والإدارة.
وبالتالي، فإن أخطر ما في التعامل مع القضية الكردية هو اختزالها في “طموحات الانفصال” أو “ارتباط بالخارج“، دون أن نسأل:
- لماذا لم يجد الأكراد مكانًا فعليًا في العقد الوطني السوري؟
- لماذا لم تكن الدولة هي مرجعهم في التمثيل؟
- ولماذا كانوا دومًا موضوعًا أمنيًا لا شريكًا سياسيًا؟
المسألة إذًا ليست خطرًا كرديًا على الدولة،
بل سؤالًا عن أي دولة تركت هذا الحيّز فارغًا ليُملأ بشبكة إدارية غير وطنية.
بعد سقوط النظام: لم تعد المسألة قابلة للتأجيل… ولا للتبسيط
اليوم، وبعد سقوط النظام المركزي، تفرض القضية الكردية نفسها بوصفها:
- ميدان اختبارٍ حاسم لمفهوم السيادة في الدولة الجديدة،
- ومرآة لمدى قدرتنا على دمج التعدد دون تفتيت، والاعتراف دون ابتزاز، والحماية دون تجزئة.
وكل محاولة لاحتواء الأكراد:
- إما بإنكار مطالبهم،
- أو بتخوينهم،
- أو بتركهم في فلك النفوذ الأمريكي،
هي محاولة فاشلة ستُعيد إنتاج سيناريو العراق أو البلقان أو سوريا نفسها، لكن بشكل أكثر خطورة.
مشروع النهضة لا يعترف بـ”حقوق الطوائف”… بل بـ”المواطنة السيادية“
إن مقاربتنا للقضية الكردية تنطلق من أساس ثابت:
لسنا أمام طائفة، بل أمام مكوّن قومي له ذاكرة ولغة ومظلومية وطموح.
ولسنا مع تفتيت الدولة باسم الحقوق، ولا مع دفن الحقوق باسم الوحدة.
بل نحن مع بناء دولة تعترف بالتعدد من داخل وحدة السيادة، وتنتج إدارة لامركزية غير مفصولة عن الانتماء الوطني.
هذه ليست فدرالية، ولا استيعابًا رمزيًا، بل هندسة إدارية–سياسية–ثقافية جديدة، تُعيد دمج المكوّن الكردي ضمن سوريا السيادية، على قاعدة: لا وصاية… لا تهميش… لا محاصصة… ولا دويلات موازية.
سوريا لا تُختصر بالعرب، ولا تتفتت بالأكراد
- إعلان أن المواطنة تسبق القومية.
• أن الدولة لا تُبنى بالتشابه بل بالعدالة.
• وأن القضية الكردية لن تُحلّ بـ”الإذابة” ولا “بالفصل”، بل بالعقد الجمهوري السيادي الذي لا يُقصي ولا يُقسِّم. 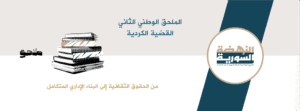
- تابعونا عبر:
- منصة X
- منصة فيسبوك


